
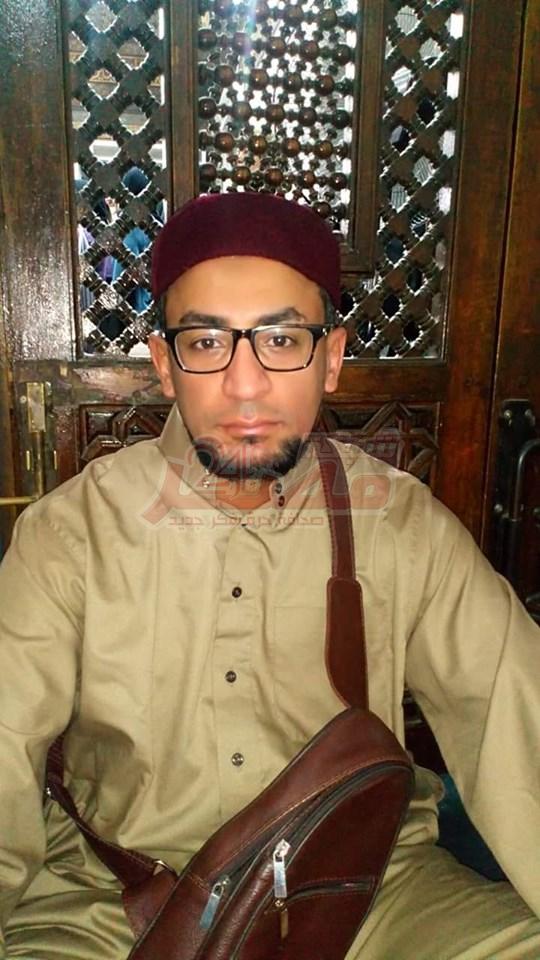
إعداد/ محمد مأمون ليله
نشر الشيخ المكرم/ أحمد محمد علي - حفظه الله تعالى- على صفحته على شبكة التعارف (الفيسبوك) ما يلي:
(القياس عند الشيخ الأكبر محمد بن علي ابن العربي الطائي الحاتمي)
أصول أحكام الشرع، المتفق عليها، ثلاثة: الكتاب، والسنة المتواترة، والإجماع. واختلف العلماء في القياس، فمن قائل: بانه دليل، وأنه من أصول الأحكام، ومن قائل بمنعه، وبه أقول.
وأما" القياس" فمختلف في اتخاذه دليلا وأصلا، فان له وجها في المعقول، ففي مواضع تظهر قوة الأخذ به على تركه، وفي مواضع لا يظهر ذلك. ومع هذا فما هو دليل مقطوع به، فأشبه" خبر الآحاد". فان الاتفاق (واقع) على الأخذ به (- خبر الآحاد)، مع كونه لا يفيد العلم وهو (أي العلم) أصل من أصول إثبات الأحكام. فليكن " القياس" مثله إذا كان جليا لا يرتاب فيه. وعندنا- وإن لم نقل به في حقى- فانى أجيز الحكم به ممن أداه اجتهاده إلى إثباته، أخطا في ذلك أو أصاب. فان الشارع أثبت حكم المجتهد وإن أخطا، وأنه مأجور. فلولا أن المجتهد استند إلى دليل في إثبات" القياس" من كتاب أو سنة أو إجماع أو من كل أصل منها، لما حل له أن يحكم به.
بل ربما يكون في حكم النظر، عند المنصف، " القياس الجلي" أقوى في الدلالة على الحكم من" خبر الواحد الصحيح"، فانا إنما نأخذه بحسن الظن بذلك" الراوي"، ولا نزكيه علما على الله، فان" الشرع منعنا أن" نزكى على الله أحدا". ولنقل (فقط): " أظنه كذا، وأحسبه كذا ".
والقياس الجلي يشاركنا فيه النظر الصحيح العقلي. وقد كنا أثبتنا بالنظر العقلي (وجود الله وتوحيد ألوهته)، الذي أمرنا به شرعا في قوله (- تعالى-): أَوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ؟ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ من جِنَّةٍ؟ وفي القرآن من مثل هذا كثير. فقد اعتبر الشارع حكم النظر العقلي في إثبات وجود الله أولا وهو الركن الأعظم، ثم اعتبره في توحيده في ألوهته. فكلفنا (الحق) النظر في أنه" لا إله إلا الله" بعقولنا، ثم نظرنا بالدليل العقلي ما يجب لهذا الإله من الأحكام، ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به في تصديق ما جاء به هذا الرسول من عنده (- تعالى-)، إذ كان بشرا مثلنا. فنظرنا بالعقول في آياته، وما نصبه دليلا على صدقه فأثبتناه. –
وهذه كلها أصول لو انهد ركن (واحد) منها بطلت الشرائع، ومستند ثبوتها النظر العقلي، واعتبره الشارع وأمر به عباده.
و" القياس" (لدى التحليل) نظر عقلى. أترى الحق يبيحه في هذه المهمات (الدينية) والأركان العظيمة، ويحجره علينا في مسألة فرعية ما وجدنا لها ذكرا في كتاب ولا سنة ولا إجماع؟ ونحن نقطع أنه لا بد فيها (- في هذه المسالة الفرعية) من حكم إلهى مشروع- وقد انسدت الطرق- فلجانا إلى الأصل وهو النظر العقلي، واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل كتابا وسنة فنظرنا في ذلك. فأثبتنا القياس أصلا من أصول أدلة الأحكام بهذا القدر من النظر العقلي، حيث كان له حكم في الأصول. فقسنا مسكوتا عنه على منطوق به لعلة معقولة، لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع، تجمع بينهما في مواضع الضرورة، إذا لم نجد فيه نصا معينا. فهذا مذهبنا في هذه المسالة.
وكل من خطأ، عندي، مثبت القياس أصلا، أو خطأ مجتهدا في فرع كان أو في أصل، فقد أساء الأدب على الشارع حيث أثبت حكمه. والشارع لا يثبت الباطل، فلا بد أن يكون (هذا الحكم) حقا، وتكون نسبة الخطا إلى ذلك (الحكم هي) نسبة أنه (أي المجتهد) أخطا دليل المخالف الذي لم يصح عند هذا المجتهد أن يكون ذلك دليلا. والمخطئ في الشرع واحد لا بعينه. فلا بد من الأخذ بقوله (- المجتهد)، ومن قوله (- المجتهد) إثبات القياس، فقد أمر الشارع بالأخذ به، وإن كان خطأ في نفس الأمر فقد تعبده به:
فإن للشارع أن يتعبد بما شاء عباده. - وهذه طريقة انفردنا بها في علمنا، مع أنا لا نقول بالقياس بالنظر إلينا، ونقول به بالنظر لمن أداه إليه اجتهاده لكون الشارع أثبته. فلو أنصف المخالف لسكت عن النزاع في هذه المسالة فإنها أوضح من أن ينازع فيها. -"
ويقول الشيخ الأكبر عن الإدلة في إبطال القياس:
ولا يجوز أن يدان الله بالرأى، وهو القول بغير حجة ولا برهان، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. وإن كنا لا نقول ب" القياس" فلا نخطىء مثبته، إذا كانت العلة الجامعة معقولة جلية يغلب على الظن أنها مقصودة للشارع. وإنما امتنعنا، نحن، من الأخذ بالقياس لأنه زيادة في الحكم، وفهمنا من الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمة، وكان يقول: " اتركوني ما تركتكم" وكان" يكره المسائل" خوفا أن ينزل عليهم في ذلك حكم فلا يقومون به، كقيام رمضان والحج في كل سنة وغير ذلك. فلما رأيناه على هذا منعنا" القياس" في الدين، فان النبي- عليه السلام- ما أمر به ولا أمر به الحق تعالى، فتعين علينا تركه فإنه مما يكرهه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. وحكم الأصل أن لا تكليف، وإن" الله خلق لنا ما في الأرض جميعا"- فمن ادعى التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. وإما" القياس" فلا أقول به ولا أقلد فيه جملة واحدة.
ويضرب الشيخ الأكبر مثال ويقول:
قال تعالى: لِيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ ولا نحتاج إلى قياس في ذلك.
مثال ذلك: رجل ضرب أباه بعصا، أو بما كان. فقال أهل القياس: لا نص عندنا في هذه المسالة. ولكن لما قال تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما: أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما، قلنا: فإذا ورد النهى عن التأفيف- وهو قليل- فالضرب بالعصا أشد، فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى، فلا بد من القياس عليه. فان التأفيف والضرب بالعصا يجمعهما الأذى، فقسنا الضرب بالعصا، المسكوت عنه، على التأفيف المنطوق به.
قلنا، نحن: ليس لنا التحكم على الشارع في شيء مما يجوز أن نكلف به، ولا التحكم (بغير نص الشارع). ولا سيما في مثل هذا. لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا لم يلزمنا القياس، ولا قلنا به، ولا ألحقناه ب" التأفيف". وإنما حكمنا مما ورد، وهو قوله- تعالى! -: وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً- فأجمل الخطاب. فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان. والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا. فما حكمنا إلا بالنص. وما احتجنا إلى قياس. فان الدين قد كمل، ولا تجوز الزيادة فيه، كما لم يجز النقص منه. فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه. ومن لم يحسن لأبيه فقد عصى ما أمره الله به أن يعامل به أبويه. ومن رد كلام أبويه، وفعل ما لا يرضى أبويه، مما هو مباح له تركه، فقد عقهما. وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر.
وفي الأخير يؤكد الشيخ الأكبر على أنه لا يخطئ من أخذ بالقياس فيقول في موضع آخر:
وقد قرر الشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروع. فاثبات المجتهد القياس أصلا في الشرع، بما أعطاه دليله ونظره واجتهاده، حكم شرعي لا ينبغي (أن) يرد عليه من ليس القياس من مذهبه، وإن كان لا يقول به، فان الشارع قد قرره حكما في حق من أعطاه اجتهاده ذلك. فمن تعرض للرد عليه، فقد تعرض للرد على حكم قد أثبته الشارع.
وكذلك صاحب القياس إن رد على حكم الظاهري، في استمساكه بالظاهر الذي أعطاه اجتهاده، فقد رد، (صاحب القياس) أيضا، حكما قرره الشارع. فليلزم كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده! ولا يتعرض إلى تخطئة من خالفه، فان ذلك سوء أدب مع الشارع، ولا ينبغي لعلماء الشريعة أن يسيئوا الأدب مع الشرع فيما قرره.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
إضافة تعليق جديد